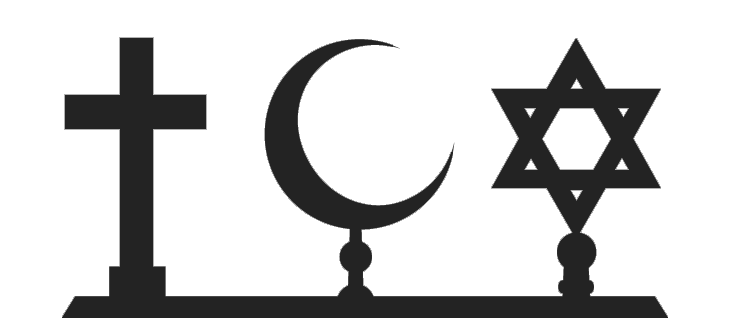الاستبداد – الدين والقبض على الحقيقة ١٦
يُفترض ان الدين مستودع إلهي للحقيقة. هو مستودع الخالق الذي يقرر، لا امورالخلق وحسب، بل حقيقة ما يجري بعد ذلك. يوحي بالحقيقة للأنبياء، وبعد الأنبياء للصحابة والتابعين وتابعي التابعين. ثم يصير العلماء ورثة الأنبياء في كل العصور.
تشكّل في عصر الأنبياء والصحابة والتابعين عصر تكويني هو ما يجب أن يُحتذى به في كل العصور اللاحقة. يصير التاريخي استرجاعاً لمرحلة تشكّل النموذج الأعلى في الذهن. مع ما يُضاف إليها ويُحذف منها، تصير هي ما نسعى إليه الى الوراء. هي ما يجب الرجوع إليه. الايديولوجيا الدينية سلفية بطبيعتها، وبالضرورة التي يفترضها أصحابها. يصير التاريخ تكراراً لما سبق في العصور السحيقة. يصير التطوّر معدوماً إن لم يستند الى السلف الصالح، ويتحوّل الى سجن توضع فيه الأذهان والعقول والأرواح. يفقد الإنسان مغزاه ومعناه. مغزى الحياة أن يتفاعل الإنسان مع حاضره كما مع ماضيه. معنى الحياة هي أن يتطوّر الإنسان ويضيف على ما سبق.
المجتمعات الإسلامية سجينة ماضيها. سجن مدى الحياة. سجن أبدي. السجين لا ينتج ولا يبدع. تُعتبر كل بدعة ضلالة مصير صاحبها النار. المجتمعات الغربية تتطوّر لأنها تبدع، لأنها خرجت من سجنها. لم تدمّر الدين لكنها تجاوزته مع الحفاظ عليه. مجتمعاتها أوسع من الدين. مجتمعاتنا الإسلامية هي كل الدين، بالأحرى الدين كل مجتمعنا.
اختصر الدين نفسه بالشريعة. هذه اعتبرت بمثابة الوحي. الوحي قرآن، والقرآن كتاب. الشريعة مجلّدات ضخمة من الكتب. تفسيرات للكتاب على مرّ العصور. كل فقيه بارز ينتج تفسيراً للكتاب. التفسيرات متنوعة ومختلفة. أوجه الاختلاف فيها كثيرة. أصحاب المذاهب لم يتورّعوا في مراحل كثيرة عن الامتثال في سبيل المذهب أي في سبيل إعلاء شأن مذهب من المذاهب. الذين يقولون بفرض تطبيق الشريعة على الدولة، يعنون فرض تفسيرهم أو مذهبهم على الدولة. ذلك يؤدي الى فرض الاختلاف على مواد الدستور. وهذا يؤدي الى تشليع الدولة، ويقود بالنهاية الى غيابها أو تغييبها. لا يمكن أن تكون مواطناً في دولة يعجّ دستورها بالتناقضات القائمة على اختلاف المذاهب. تتحوّل المذاهب قسراً من طرق للإيمان الى وسائل لتدمير الدولة. الاستبداد السياسي والمدني يدمر الدولة ويتحالف مع الدين من أجل ذلك.
يقاتل أهل المذهب بعضهم لأن كلاً منهم يعتبر نفسه قابضاً على الحقيقة الإلهية. يضع نفسه مكان الذات الإلهية. يقاتل أهل المذاهب السنّية بعضهم. ويقاتل أهل المذاهب الشيعية بعضهم. كما يقاتل بعض أهل السنة بعض الشيعة.
القبض على الحقيقة نوع من الاستبداد. القبض على الحقيقة الإلهية استبداد مطلق. لا يستطيع القابض على الحقيقة إلا أن يعتبر نفسه متسامياً على الآخرين، متفوقاً عليهم أخلاقياً وأدبياً ومادياً. القابض على الحقيقة يرهن نفسه لها؛ يسجن نفسه ضمن أسوارها؛ يعتبر الآخرين خصوماً أو أعداء له. الحقيقة المطلقة تدمير مطلق للذات وللآخرين. ليس مع الحقيقة تواضع. هي تجرّ الى الاستكبار، والاستعلاء، والاستهانة بالآخرين. هي كذلك مؤدية الى الاستهانة بالواقع. تتعالى الذات على الموضوع. تصل في استعلائها الى الالتصاق بالذات الإلهية أو اعتبار نفسها الناطقة الوحيدة باسمها.
القابض على الحقيقة يمنعها عن غيره. يصير أتباع المذاهب الأخرى أعداء له؛ لأنهم أعداء للحقيقة أو مخالفون لها. يصير الاختلاف في المذهب افتراقاً ونزاعاً مع الذات الإلهية. كأنّ الذات الإلهية بحاجة لمن يدافع عنها.
إذا كان الاستبداد السياسي يحدّ من حرية الرأي فإن الاستبداد الديني يحدّ من حرية الفكر والعقل. احدهما ينتج العبودية والآخر ينتج التفاهة. في الحالتين يحدث انغلاق المجتمعات العربية والانغلاق عن العالم والخوف من الثقافة العالمية والخوف على الثقافة الإسلامية من الاستيعاب في الثقافة العالمية. هذا يؤدي الى تناقض كبير. اعتزاز كبير بماض لم يعد موجوداً وخوف من حاضر ينوء بثقله علينا. يفقد العقل سويّته. تتعطّل ملكة التهذيب. يتعطل السياق، تتحكّم العشوائية في الذهن. تصبح سلوكياتنا غير مفهومة، حتى بالنسبة إلينا. نؤدّي الطقوس من دون أن نفهم معناها. يزاح الايمان الى المقعد الخلفي.
نقبض على حقيقة إلهية ونُهزم في الحين ذاته. هل انّ الله معنا أم نحن معه وحسب؟ هل لنا حساب في هذه الدنيا؟ في خبايا أنفسنا نعتقد أننا صفر. وأننا لا يحسب لنا حساب. نيأس من هذه الدنيا. نقوم بعمليات انتحارية، حتى كادت تصبح حكراً على المسلمين في هذا العالم.
لسنا من يجب أن نكون. آمالنا وطروحاتنا صارت مستحيلة. بعد عقود من الاستقلال، يقرر مصيرنا الغير من القوى الإقليمية والدولية. تفاهاتنا تجاوزت الانفصام. الانفصام نفسي. يُضاف إليه مسافة كبيرة بين والإنتاج والاستهلاك. ننتج (يُنتج لنا) ما لا نستهلك، ونستهلك ما لا ننتج. عملياً لا مبادلة بين ما نصدّر وما نستورد. لأنهم يصدّرون النفط بالنيابة عنا، ونستورد بما يتركونه لنا من عائدات. عملياً نستهلك ولا ننتج. يزداد احتقارنا لأنفسنا. نشعر أننا عالة على هذا العالم. نحن عبء عليه، لا نساهم فيه. كيف نساهم ثقافياً وحضارياً في عالم لا نساهم فيه إنتاجياً. مستقبلنا يُصنع لنا. يعاملنا الجميع كالأطفال. احترام التاريخ من قبل باحث غربي عن المنطقة لا وجود له في الراهن. لا نستحقّ الاحترام. لا نحترم أنفسنا. دونيّة تجاه الغرب. عنصرية معكوسة. استكبار مفتعل حيال الماضي. تواضع دوني حيال الحاضر. لم نعد نستطيع أن نكون موضوعيين حيال الماضي أو الحاضر.
بعد عقود من سنين الاستقلال نطرح على أنفسنا السؤال: من أين نبدأ؟ الجواب الشائع هو أن الإصلاح الديني صار ضرورة. وكأن الدين بحاجة الى إصلاح، أو يمكن إصلاحه. الإصلاح الديني مثل شعار تطبيق الشريعة يحتاج الى مئات السنين، إذا كان ممكناً عمليا، وهو غير ممكن. القول بالإصلاح الديني هو كالقول بتطبيق الشريعة، وهذا أساس الاختلافات والحروب التي لا نعلم آخرها.
ما نحتاجه هو تجاوز الدين في النظر الى مشاكلنا. هذا يحتاج الى منهجية غير دينية. الحداثة لا تعني الإصلاح الديني. الإصلاح الديني لا يعني الاعتدال في الدين، إذ أن الاعتدال الديني مستحيل (لا يمكن الاعتدال بشأن الحقيقة المطلقة). المطلوب أن نجيب على مشاكل جديدة بعقل مستجد. الحداثة هي في هذا العقل المستجد الذي نهمل البحث عنه. ليست الحداثة وصفة جاهزة. هي كالاجتهاد سعي في سبيل أجوبة راهنة وحلول عصرية للمشاكل التي يواجهها مجتمعنا.
يعتبر البعض أن العلمانية تقضي بفصل الدين عن الدولة. فكأن ذلك لم يكن واقع المجتمع منذ أيام الإسلام الأولى. للدين رجاله وللسياسة رجالها. هذه كانت الحال في كل العصور. وهناك مؤسسات دينية وأخرى مدنية. لكن ما نحتاجه الآن هو أن يحتلّ الدين مجاله في الحياة اليومية. ليس الإسلام هو الحل لكل شيء كما يدّعي الاخوان المسلمون والسلفيون. “أنتم أعلم بشؤون دنياكم” كما يُنسب الى النبي. للدين مجاله وهو الإيمان الفردي والممارسات الجماعية الضرورية، وكل ما عدا ذلك من شؤون اجتماعية واقتصادية وسياسية وعسكرية، الخ… يقع خارج الدين. المطلوب هو أن يصبح الدين أحد مجالات النشاط البشري. فيستمدّ الواحد منا الحلول لمشاكل جديدة، لم تطرأ قديماً، بعقل مستعدّ لقبول الجديد من الحلول. هذا هو المطلوب. نعم. مطلوب التجاوز بمعنى حصر الدين في مجاله الذي يليق به، شرط أن يكون مجاله محصوراً، وشرط أن ترضى الذهنية السائدة بذلك. والشرط الأكبر هو تراجع الاستبداد السياسي كي يخفّ الضغط على النفس البشرية، وكي ينفكّ الدين عن غيره من مجالات النشاط. لا يمكن شطب الدين من الوجود، ولا يمكن إلغاؤه أو إخضاعه لغيره من النشاطات السياسية. المطلوب وضعه في مجاله الخاص والحرص على أن لا يعتدي على المجالات الأخرى. يبقى الإيمان ضرورياً. يحتاج الإنسان الي ايمان من نوع ما. من شاء فليؤمن. وليكن إيمانه منبعثاً من ضميره لا مجرد طقوس يجري تردادها ببغاوياً.
الإلحاح على الطقوس، والإصرار على أولويتها يجعل الدين نوعا من الاستبداد أشدّ وأدهى من الاستبداد السياسي؛ لا يوجد منافسة بين الإثنين بل تحالف بينهما. الطاغية في السياسة يتحالف مع “علماء” الدين على الدوام. في هذا التعاون استبداد مزدوج. وهو مصدر الخراب. هذا ما أدى إليه تحالف الشيخ والأمير. وقد صار هذا التحالف ممكناً بواسطة النفط الذي استخدم لتصدير هذا التحالف السلفي الماضوي. تحالف الاستبداد الديني والاستبداد السياسي إهانة للدين، لأنه يصاب بنفس تفاهة الطاغية. تحالف الدين والاستبداد هو في أساس ما نحن عليه. وما نحن عليه لا يبعث على الفخر. ما نحن عليه هزيمة مهينة أمام صهيونية مستوردة قليلة العدد. يأبى البعض الاعتراف بالهزيمة في سبيل تمجيد ماض لم يعد موجوداً. الله ليس معنا. لأننا لسنا مع أنفسنا ولسنا على سوية من أمرنا. إذا كان اللع يسيّر العالم كل لحظة، كما يدّعي الأشاعرة، فإنه يعاقبنا على ما نحن فيه. هذا حجاج سفسطائي.
الماء: الى مزيد من الشح، والأمطار لا تكفي. الأنهار الكبرى تنبع من غير أرضنا. الزراعة: نحن نستورد معظم القمح للغذاء. الصناعة: لا نعرف عنها شيئاً. الخدمات: أوامر الطاغية يجري تلبيتها بكل حذافيرها. مجتمع مغلق ثقافياً، ويسير مادياً نحو الانهيار أو التلاشي. الدين لا يجيب على أي من تلك المشاكل لسبب بسيط: لا دخل له بها. النشاط والعمل في المجالات غير الدينية هو المطلوب. تقاليدنا وديننا السائد لا تفيد شيئاً في حلّ مشاكل الحاضر. العقل والسعي وحدهما يفيدان. نحن أمة مقعدة كسيحة. لا يجوز أن يستولي القفا على رأس الإنسان. لكن هذا ما حصل بفعل تحالف الطغيان والدين؛ وصار الدين طغياناً آخر. التفاهة التي أدى إليها الطغيان يؤكدها الدين بشكلها الحالي.
الدين غير الإيمان. الدين سلطة اجتماعية. الإيمان فردي. الإيمان لا يفيد الله بل يفيد صاحبه. العمل الاجتماعي شبكة علاقات بين الناس لا موضع فيها للدين إلا جزئياً.